في معرفة النفس*
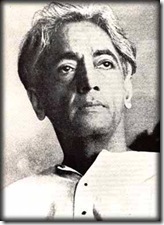
ج. كريشنامورتي
حسبنا أن ننظر إلى العالم من حولنا حتى نرى البلبلة والبؤس والرغبات المتنازعة. وأغلب الناس المبالين والجدِّيين، – لا الناس الذين يلعبون لعبة التظاهُر، بل الناس المهتمُّون حقًّا، – إذ يدركون هذا العماء العالمي، سوف يرون بطبيعة الحال أهمية التفكر في مشكلة العمل. هناك العمل الجماهيري والعمل الفردي؛ و”العمل الجماهيري” صار مفهومًا مجردًا، مَهْربًا ملائمًا للفرد. فالفرد، إذ يظن أن هذا العماء، – هذا البؤس، هذه النكبة التي لا تنفك تتصاعد، – يمكن للعمل الجماهيري أن يحوِّله أو أن يُحِلَّ فيه النظام، تراه يصير غير مسؤول. “الجماهير” قطعًا كيان متخيَّل؛ فالجماهير هي أنت وأنا. ففقط حين لا نفهم – أنت وأنا – علاقة العمل الصحيح، ترانا نلوذ بالمفهوم المجرَّد المسمَّى “الجماهير” – وبذا نصير غير مسؤولين في عملنا. ومن أجل الإصلاح في العمل نبحث إما عن قائد وإما عن العمل المنظَّم الجماعي، وهو عمل “جماهيري” هو الآخر. وعندما نلوذ بقائد طلبًا للتوجيه في العمل، ترانا لا محالة نختار شخصًا نظن أنه سوف يعيننا على تجاوز مشكلاتنا نحن، بؤسنا نحن. لكن القائد نفسه – لأننا نختار قائدنا اعتبارًا من بلبلتنا – قائد مبلبل هو الآخر. فنحن لا نختار قائدًا إلا ويشبه أنفسنا؛ إذ لا نستطيع… لا نستطيع إلا أن نختار قائدًا مبلبلاً مثلنا؛ لذا فإن أمثال هؤلاء القادة، أمثال هؤلاء المرشدين والـگورو [المعلِّمين] الروحيين المزعومين، يقودوننا لا محالة إلى مزيد من البلبلة، إلى مزيد من البؤس. وبما أن ما نختار لا بدَّ وأن نختاره اعتبارًا من بلبلتنا فإننا حين نتبع قائدًا ترانا لا نتبع إلا إسقاطنا الذاتي المبلبل. لذا فإن مثل هذا العمل، مع أنه قد يثمر عن نتيجة فورية، يقود لا محالة إلى مزيد من النكبات.
ومنه، نرى أن العمل الجماهيري – مع أنه قد يكون ذا قيمة في بعض الحالات – يقود حتمًا إلى النكبة، إلى البلبلة، ويجلب انعدام المسؤولية من جانب الفرد، وأن التبعية لقائد لا بدَّ أن تزيد من البلبلة هي الأخرى. ومع ذلك، علينا أن نحيا. الحياة هي العمل؛ الوجود هو العلاقة. لا عمل ثمة من دون علاقة، ولا يمكن لنا أن نحيا معزولين. ليس هناك شيء اسمه العزلة. فالحياة هي أن نعمل وأن نكون على علاقة. ومنه، حتى نفهم العمل الذي لا يفتعل المزيد من البؤس، المزيد من البلبلة، علينا أن نفهم أنفسنا، بكلِّ تناقضاتنا، بعناصرنا المتضادة، بأوجُهنا العديدة التي لا ينفك بعضها يتصارع مع بعضها الآخر. فإلى أن نفهم أنفسنا، لا بدَّ للعمل من أن يقود حتمًا إلى مزيد من النزاع، إلى مزيد من البؤس.
مشكلتنا، إذن، هي العمل المصحوب بالفهم؛ وذاك الفهم لا يمكن له أن يحصل إلا عبر معرفة النفس. فالعالم، في النهاية، هو إسقاط لنفسي: ما أنا إيَّاه يكونه العالم؛ العالم ليس مختلفًا عني، العالم ليس مضادًّا لي. العالم وأنا لسنا كيانين اثنين منفصلين. المجتمع هو نفسي؛ ليس هناك سيرورتان مختلفتان. العالم امتداد لنفسي، ولفهم العالم، عليَّ أن أفهم نفسي. الفرد ليس متعارضًا مع الجماهير، مع المجتمع، لأن المجتمع هو الفرد بالذات. المجتمع هو العلاقة بينك وبيني وبين الآخر. لا يوجد تضادٌّ بين الفرد والمجتمع إلا حين يصير الفرد غير مسؤول. مشكلتنا، إذن، لا يُستهان بها. هناك أزمة مهولة تواجه كلَّ بلد، كلَّ شخص، كلَّ جماعة. فما هي طبيعة علاقتنا – أنت وأنا – بتلك الأزمة، وكيف سنعمل؟ من أين نبدأ من أجل أن نُحدِثَ تحوُّلاً؟ كما قلت، إذا لذنا بالجماهير لن نجد مخرجًا، لأن الجماهير تقتضي وجود قائد، والجماهير يستغلُّها دومًا السياسي والكاهن والخبير. وبما أنك وأني نصنع الجماهير، لا مناص لنا من تحمُّل المسؤولية عن عملنا؛ أي أن علينا أن نفهم طبيعتنا نحن، علينا أن نفهم أنفسنا. وفهم أنفسنا لا يتم بالانسحاب من العالم، لأن الانسحاب يقتضي العزلة، ولا نستطيع أن نعيش معزولين. ومنه، علينا أن نفهم العمل في العلاقة، وذاك الفهم يتوقف على وعينا طبيعتَنا نحن، المتنازعة والمتناقضة. أعتقد أن من الحمق أن نتصور حالاً يسودها السلام بوسعنا أن نتطلَّع إليها. لا يمكن أن يوجد سلام وطمأنينة إلا حين نفهم طبيعة أنفسنا ولا نفترض سلفًا حالاً لا نعرفها. قد تكون هناك حال سلام، لكن مجرد التكهُّن حولها لا جدوى منه.
من أجل العمل السليم، لا بدَّ من التفكير السليم؛ ومن أجل التفكير السليم، لا بدَّ من معرفة النفس؛ ومعرفة النفس لا تحصل إلا عبر العلاقة، لا عبر العزلة. لا يمكن للتفكير السليم أن يأتي إلا بفهم أنفسنا الذي ينبجس منه العمل السليم. العمل السليم هو العمل الذي ينبع من فهم أنفسنا: لا فهم جزء واحد من أنفسنا، بل فهم محتوى أنفسنا برمَّته، طبائعنا المتناقضة، كل ما نحن إيَّاه. ونحن، حين نفهم أنفسنا، يتمُّ العمل السليم؛ ومن ذلك العمل توجد السعادة. وفي الحاصل، فإن السعادة هي ما نريد، هي التي يطلبها أغلبنا عبر أشكال متنوعة، عبر مختلف المهارب – مهارب النشاط الاجتماعي، مهارب العالم البيروقراطي، التسلية، العبادة وتكرار العبارات، الجنس، ومهارب أخرى لا تُحصى. لكننا نرى أن هذه المهارب لا تجلب سعادة مستديمة، بل تجلب تسكينًا مؤقتًا وحسب. فما من شيء حقيقي فيها، ما من بهجة مستديمة أساسًا. أعتقد أننا سنجد تلك البهجة، تلك النشوة، فرح الوجود المبدع الحقيقي ذاك، فقط حين نفهم أنفسنا. لكن فهم أنفسنا هذا ليس سهلاً، بل يتطلب تيقظًا، وعيًا معيَّنًا. وذاك التيقظ، ذاك الوعي، يمكن له أن يأتي فقط حين لا ندين، حين لا نبرِّر، لأنه لحظة ندين أو نبرِّر نضع حدًّا لسيرورة الفهم. حين ندين أحدهم نكفُّ عن فهم ذلك الشخص، وحين نتماهى مع ذلك الشخص نكفُّ عن فهمه أيضًا. والأمر مماثل مع أنفسنا. رَصْدُ نفسك، وعيُ ما أنت إيَّاه وعيًا سالبًا، من أصعب ما يكون، ولكن من ذاك الوعي السالب يأتي فهمٌ، يأتي تحوُّلٌ للـموجود، ووحده ذاك التحوُّل يفتح الباب للحق.
مشكلتنا، إذن، هي العمل والفهم والسعادة. ولا أساس للتفكير الصحيح ما لم نعرف أنفسنا. من غير أن أعرف نفسي لا أساس عندي للتفكير – بوسعي فقط أن أعيش في حال تناقُض، كما يفعل معظمنا. حتى أُحدِثَ تحولاً في العالم – وهو عالم علاقتي – لا بدَّ لي من أن أبدأ بنفسي. رُبَّ قائل يقول: “إحداث تحوُّل في العالم بتلك الطريقة يستغرق وقتًا طويلاً لا ينتهي.” إذا كنَّا نطلب نتائج فورية فبطبيعة الحال سنظن أن الأمر يستغرق وقتًا أطول مما ينبغي. النتائج الفورية يَعِدُ بها السَّاسةُ، أما الإنسان الذي يطلب الحقيقة فأخشى ألا توجد عنده نتيجة فورية. الحقيقة هي التي تحوِّل، لا العمل الفوري؛ ووحده اكتشاف كلِّ واحد للحقيقة سيجلب السعادة والسلام إلى العالم. الحياة في العالم، لكنْ من غير أن نكون من العالم، هي مشكلتنا؛ وإنها لمشكلة سعي مخلص، لأننا لا نستطيع أن ننسحب، لا نستطيع أن نزهد، بل علينا أن نفهم أنفسنا. فهم المرء نفسَه هو بداية الحكمة. وفهم المرء نفسَه هو فهمُه علاقتَه مع الأشياء والناس والأفكار. فإلى أن نفهم مغزى علاقتنا كاملاً مع الأشياء والناس والأفكار ومعناها التام فإن العمل – وهو العلاقة – سيجلب حتمًا النزاع والصراع. لذا لا بدَّ للإنسان المخلص حقًّا من أن يبدأ بنفسه؛ عليه أن يكون واعيًا وعيًا سالبًا بأفكاره ومشاعره وأفعاله كلِّها. للمرة الثانية، هذه ليست قضية زمن. فمعرفة النفس لا نهاية لها. معرفة النفس هي فقط من لحظة للحظة، وبالتالي، هناك سعادة خلاقة من لحظة للحظة.
*
حين أتعامل مع أسئلتكم، رجاءً لا تنتظروا جوابًا؛ لأني وإيَّاكم سنتفكَّر في المسألة معًا ونجد الجواب في المسألة. إذا انتظرتم جوابًا وحسب أخشى ما أخشاه أن أملكم سوف يخيب. فالحياة ليس عندها “نعم” أو “لا” قاطعتان، مع أن هذا ما نتمنى. الحياة أعقد من ذلك وأرهف. ومنه، حتى نجد الجواب، علينا أن نتدارس المسألة؛ ما يعني أننا يجب أن نتحلَّى بالصبر والفطنة للتعمق فيها.
سؤال: ما هي مكانة الدِّين المنظَّم في المجتمع الحديث؟
كريشنامورتي: دعنا نتحرى عما نعنيه بـ”الدين” وما نعنيه بـ”المجتمع الحديث”. ماذا نعني بالدِّين؟ ماذا يعني الدِّين بنظرك؟ إنه يعني – ألا يعني؟ – جملة معتقدات، شعائر، عقائد، خرافات عديدة، پوجا [عبادة]، تكرار كلمات، آمالاً مبهمة، غير مستجابة، محبَطة، قراءة كتب بعينها، تبعية للـگورو، الذهاب إلى المعبد في بعض المناسبات، إلى ما هنالك. ذاك كلُّه، قطعًا، هو الدِّين بنظر أكثر الناس عندنا. ولكن هل ذاك هو الدِّين؟ هل الدِّين عرف، عادة، تقليد؟ الدِّين، قطعًا، شيء أبعد من هذا كلِّه بكثير، أليس كذلك؟ الدِّين يقتضي البحث عن الحق، وهو لا يمتُّ بأيِّ صلة إلى الاعتقاد المنظَّم، المعابد، العقائد، أو الشعائر؛ ومع ذلك، فإن تفكيرنا، قوام وجودنا بالذات، عالِقٌ، واقعٌ في شَرَك المعتقدات والخرافات إلى ما هنالك. من الواضح أن الإنسان الحديث ليس ديِّنًا؛ لذا فإن مجتمعه ليس مجتمعًا صحيحًا، متوازنًا. قد نتبع مذاهب بعينها، أو نتعبَّد لصور بعينها، أو نبتكر دين دولة جديد، لكن من الواضح أن هذه الأشياء كلَّها ليست من الدِّين في شيء. قلت إن الدِّين هو البحث عن الحق، لكن ذاك الحق غير معلوم؛ إنه ليس الحق القابع في الكتب، ليس خبرة الآخرين. وللعثور على ذاك الحق، للكشف عنه، لدعوته، لا بدَّ للمعلوم من أن يتوقف؛ كما يجب إمعان النظر في المغزى من جميع التقاليد والمعتقدات، فهمها، ونبذها. ولفعل هذا، لا معنى لتكرار الشعائر. لذا من الواضح أن الإنسان الديِّن حقًّا لا ينتمي إلى أيِّ دين، إلى أيِّ تنظيم؛ إنه ليس هندوسيًّا ولا مسلمًا؛ إنه لا ينتمي إلى أيِّ طبقة.
والآن، ما هو العالم الحديث؟ العالم الحديث قوامه التقنية وفعالية التنظيمات الجماهيرية. هناك تقدُّم هائل في التكنولوجيا، مع سوء توزيع لحاجات الجماهير؛ وسائل الإنتاج حكر على أيدي ثلَّة صغيرة. هناك قوميات متنازعة، حروب متكررة على الدوام تفتعلها حكومات “ذات سيادة”، إلى ما هنالك. ذاك هو العالم الحديث، أليس كذلك؟ هناك تقدُّم تقني من غير تقدُّم نفساني مساوٍ له في الحيوية، وإذن، فهناك حالة اختلال توازن؛ هناك إنجازات علمية خارقة، وفي الوقت نفسه، بؤس بشري، قلوب خاوية، وأذهان فارغة. والعديد من التقنيات التي تعلَّمناها يتصل ببناء الطائرات، بقتل بعضنا بعضًا، إلى ما هنالك. وإذن، فذاك هو العالم الحديث، الذي هو أنت نفسك. العالم ليس مختلفًا عنك. عالمك – الذي هو أنت نفسك – هو عالم العقل النامي والقلب الخاوي. إذا أمعنتم النظر في أنفسكم سترون أنكم بالذات نتاج المدنية الحديثة: أنتم تعرفون كيف تؤدون بضع حيل، – حيل تقنية، مادية، – لكنكم لستم كائنات إنسانية مبدعة. أنتم تنجبون أطفالاً، لكن هذا ليس من الإبداع في شيء! فحتى يستطيع المرء أن يبدع يحتاج إلى غنى داخلي خارق، وذاك الغنى لا يمكن له أن يحصل إلا حين نفهم الحقيقة، حين نكون قادرين على استقبال الحقيقة.
وإذن، فالدِّين والعالم الحديث متلازمان، كلاهما ينمِّي القلب الخاوي – وذاك هو الجانب المؤسف من حياتنا. نحن سطحيون، لامعون عقليًّا، قادرون على اختراعات عظيمة وعلى إنتاج أكثر الوسائل تدميرًا لتصفية بعضنا بعضًا، وعلى إيجاد مزيد ومزيد من الانقسام بين بعضنا بعضًا، لكننا لا نعرف ما معنى أن نحب، ليست هناك أغنية في قلوبنا. ترانا نعزف الموسيقى، نستمع إلى الراديو، ولكن لا غناء ثمة، لأن قلوبنا خاوية. لقد خلقنا عالمًا مبلبلاً تمامًا، بائسًا، وعلاقاتنا مهلهلة، سطحية. أجل، الدِّين المنظَّم والعالم الحديث صنوان، لأن كلاهما يقود إلى البلبلة، وبلبلة الدِّين المنظَّم والعالم الحديث هذه هي جنى أيدينا. إنهما التعبيران المسقَطان ذاتيًّا عن أنفسنا. ومنه، لا مجال لأيِّ تحوُّل في العالم الخارجي ما لم يحدث تحوُّل في صميم كلِّ واحد منَّا؛ وإحداث ذاك التحوُّل ليس مشكلة الخبير أو الاختصاصي أو القائد أو الكاهن، بل مشكلة كلِّ واحد منَّا. إذا تركناها للآخرين، بتنا غير مسؤولين، وبالتالي فإن قلوبنا تصير خاوية. والقلب الخاوي مع عقل تقني ليس كائنًا إنسانيًّا مبدعًا؛ ولأننا أضعنا حالة الإبداع تلك، ترانا أنتجنا عالمًا بائسًا، مبلبلاً تمامًا، تحطِّمه الحروب، تمزِّقه التمييزات الطبقية والعرقية. وإنها لمسؤوليتنا أن نُحدِث تحولاً جذريًّا في أنفسنا.
نيودلهي، 14 تشرين الثاني 1948
* From the Verbatim Report of the first public talk in New Delhi, 14 November 1948, in Collected Works of J. Krishnamurti, copyright ©1991 Krishnamurti Foundation of America.