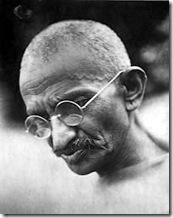هل اللاعنف = “لا” للعنف؟
بين ج. كريشنامورتي وم. ك. گاندهي*
ديمتري أڤييرينوس
ج. كريشنامورتي وموهنداس ك. گاندهي شخصيتان منيفتان من القرن العشرين. كلاهما ولد في الهند وتعلَّم في الغرب، وكان لتعاليمهما ولفلسفتيهما وَقْعٌ من العالمية والشمول بحيث صارت موضع تقصٍّ واسع النطاق في العالم أجمع؛ وكلاهما كان مجاهدًا في طلب الحقيقة. قد يبدوان خارجيًّا، من حيث أسلوب الحياة، مختلفين جدًّا، لكن علينا أن نتخطى المظاهر الخارجية حتى نفهم مغزى حياة كلٍّ منهما فهمًا عميقًا. ومنه، ليس بنيتي أن أعقد مقارنة بين الرجلين، ولا أن أقوِّم أيهما أعظم – فمن القحة، أولاً، أن نفترض في نفسنا القدرة على الحكم على أي إنسان أو قياسه بمسطرتنا؛ ناهيكم عن أن مثل هذا المسعى مسعى عقيم لأن محاولة المقارنة بين إنسانين عظيمين وتعيين “مرتبة” لكلٍّ منهما على سلَّم متخيَّل للتحقق الروحي والإنساني لا يقودنا أصلاً إلى فهم أعمق لأنفسنا، في أنفسنا، بأنفسنا. الأجدر بنا، إذن، أن نتوقف عند ما يمكن لنا أن نتعلمه من تعليم كلٍّ منهما، أولاً، ومن حياته، ثانيًا.
لقد كانت الغايات التي وضعها كلٌّ من كريشناجي وگاندهيجي نصب عينيه في حياته متشابهة، لكنها في الوقت نفسه، من حيث التطبيق، متباينة تباينًا ذا دلالة. فكلاهما كان من “الخوارج” على النظام الاجتماعي السائد من حوله، وكلاهما كان مهتمًّا بإحداث تحوُّل باطني عميق في الإنسان. كان تحقيق الذهن الديِّن the religious mind هو الرسالة التي ندب لها كلٌّ منهما نفسه وحياته، كلٌّ بطريقته. فكريشنامورتي الذي تقصَّى هذه المسألة تقصِّيًا عميقًا في شبابه وقف نفسه على تحرير الإنسان: تحريره من “عكاكيزه” المادية والنفسية، من قيوده وإشراطاته، من أوهامه القاتلة – وهي، بمعنى ما، رسالة مشابهة للرسالة التي نذر لها البوذا نفسه وحياته؛ وإذ تحقق بالحقيقة التي انكشفت له، أراد أن يعين رفاقه البشر على اكتشافها والتحقق بها بأنفسهم[1]. ولقد كان گاندهي هو الآخر مهتمًّا بهذه المجاهدة الروحية اهتمامًا مركزيًّا، لكنه نذر نفسه وحياته لبلوغ أهداف اجتماعية محددة للغاية: أراد أن يعمل في سبيل استقلال الهند السياسي، في سبيل اجتثاث الفقر والخرافات، في سبيل الإصلاح الاجتماعي في منزلة النساء والمنبوذين hārijans، في سبيل التخفيف من وطأة نظام الطوائف الاجتماعي cast system، إلى آخر ما هنالك[2].
أما كريشنامورتي، فلم يعبأ كثيرًا بمثل هذه القضايا المحلية في أي بلد بعينه من بلدان العالم، فظل اهتمامه كوكبيًّا شاملاً – وهذا لا لأنه لم يبالِ بالإصلاح الاجتماعي، بل لأنه قال بأن أي تغيير جذري في المجتمع لا يمكن له أن يتم ما لم يتحقق تغيير مماثل في وعي الفرد أولاً. المسألة بنظره ليست مسألة اعتناق دين معيَّن أو فلسفة بعينها أو اتِّباع أحدهم والتأسِّي به في حياته؛ كما لا يحدث التغيير عبر التقيد بوصايا معينة أو نَذْر نذر معين والإصرار على التزامه – فهذا كله بنظره ليس إصلاحًا على الإطلاق. لذا كثيرًا ما كرر: “أنت العالم، والعالم أنت”[3] – ما يقتضي أن العالم لا ينصلح أمرُه فعلاً ما لم نصلح أنفسنا أولاً. وقد شرح هذا الارتباط العضوي بين الفرد والمجتمع في تعليمه شرحًا مفصلاً: كان يرى أنه مادام البشر أنانيين، مستأثرين، كارهين، عدوانيين، عنيفين، فما من نظام اجتماعي من شأنه أن يوجِد مجتمعًا مسالمًا ومنسجمًا (= لاعنفيًّا). المجتمع مؤلف من أفراد، وإذا كان عندنا مجتمع يضم ملايين الأفراد، كلٌّ منهم متمركز على نفسه، طَموح، جشع، عنيف، فمهما نُظِّم هذا المجتمع على غرار گاندهي، أو وفقًا لمبادئ شيوعية، أو على أساس رأسمالي، فإن العنف الكامن في الفرد سيظهر في المجتمع حتمًا، ومهما احتُوي في اتجاهات معينة، فإنه سيبرز في اتجاهات أخرى.
كذا فقد كان في المجتمع “الشيوعي” عنف شديد، كما نعلم؛ وفي المجتمع الرأسمالي، الحرِّ زعمًا، هناك كذلك عنف هائل، وإنْ يكن من نمط مختلف. مجرد “احتواء” العنف و”تقنينه” عبر الديمقراطية لا يتمخض، حسب كريشنامورتي، عن أي تغيير جذري. لذا طالب بإيقاد ثورة داخلية كلية في نفس الإنسان، ووضع نصب عينيه إشعال فتيلها في نفوس مستمعيه وأذهانهم: على وعي الإنسان أن يتغير تغيرًا عميقًا من الداخل، وما لم يحدث هذا، فإننا نتلاعب بالأعراض الخارجية وحسب و”نرقع” باسم الإصلاح الاجتماعي؛ الطريقة التي يتم بها ذلك الإصلاح تحوي أصلاً عناصر الطموح والانقسام والعدوانية، فلا تلبث العواقب أن تطفو على السطح. ومع أنه قد يبدو، للوهلة الأولى، أن الإصلاح الاجتماعي قد أحلَّ شيئًا من النظام في المجتمع، فهذا من قبيل الوهم، لأن ذلك النظام سوف ينكسر لا محالة، الأمر الذي يتطلب إصلاحًا جديدًا يتغلب على الفوضى الجديدة، وهكذا دواليك حتى أجل غير مسمَّى!
لقد شهدت البشرية أعمال مصلحين عظام، واندلعت ثورات دامية، لكنها ما لبثت أن أسست لصنوف جديدة من الاستبداد، فكان لا بدَّ من الثورة على الاستبداد الجديد. قد يبدو مؤقتًا أن الاستبداد القديم سقط، ولكنْ مادام البشر مستبدين، فمآلهم أن يؤسسوا لاستبداد جديد. لذا شعر كريشنامورتي أن الإصلاح في أسس المجتمع ليس تمردًا ضمن جدران سجن بهدف تحسين ظروف إقامة السجناء، بل هو، قبل كل شيء، تحطيم لجدران السجن من أساسها – وهذا لا يتم إلا عبر التحول الداخلي، وليس عبر مجرد التغيير الخارجي الذي ما انفك المصلحون والثوار يحاولون إحداثه في المجتمع.
* * *
اعترض كريشنامورتي كذلك على مفهوم التبعية لأي مذهب، فلسفيًّا كان أو دينيًّا أو سياسيًّا – رفض “ياء النسبة” على صعيد الحياة الفردية والاجتماعية والروحية، متسائلاً في عمق: “ماذا يعني هذا؟” ماذا يعني قولي: “أنا بوذي” أو “أنا إسلامي” أو “أنا مسيحي” أو “أنا گاندهيٌّ”؟ لا بدَّ لنا من تفحُّص أساس هذا السؤال تفحُّصًا جديًّا عميقًا، لأننا غالبًا ما نكتفي بتعريف سطحي جدًّا للكلمات يأخذ به الناس من غير تروٍّ. ماذا يعني أن يكون المرء گاندهيًّا؟ هل يعني الجلوس وراء دولاب الغزل chakra؟ هل يعني لبس الـخادي khadi (القماش القطني المحلي)؟ هل يعني الإيمان باللاعنف وسيلةً للحصول على مكاسب سياسية؟ أم أنه يعني التوصل إلى فهم داخلي، عميق في سريرة النفس، للمحبة والرحمة اللتين تجلتا في حياة گاندهي؟ هل مجرد إعلان النية يجعلني گاندهيًّا؟ وماذا يعني ذلك حقًّا؟ وهل بوسع المرء أن يمارس اللاعنف حقًّا، أو يقرر ممارسته في حياته، مادام عنيفًا في دخيلة نفسه؟
العنف، عند كريشنامورتي، أبعد بكثير من مجرد مظاهره الخارجية؛ لذا لم يقبل تعريف اللاعنف بوصفه مجرد عدم الرد على العنف الفيزيائي بعنف مثله. فعنده أن الغضب والغيرة والطمع والاستئثار – وكلها ناجم عن التماهي مع الصورة التي يشكلها المرء عن نفسه[4] – أشكال متنوعة من العنف، وأنه مادامت هذه كامنة في الداخل، فإن الأخذ باللاعنف مذهبًا سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو حتى سلوكيًّا لا يعني شيئًا يُذكَر. فمن تصريحاته المتكررة أن “الفضيلة لا تنمَّى”. إنها حال ذهنية وقلبية، إما أن يشعر بها المرء فعلاً، فتنسحب على حياته كلها، وإما أن لا يشعر بها، فيستعيض عنها بقرار “السعي إليها”. كالحب تمامًا: هل يُعقَل أن “أقرر” بأن أحب؟! إما أن أحب، فأبذل نفسي بلا مقابل إطلاقًا، وإما لا.
إذا كان الذهن متمركزًا على ذاته، عدوانيًّا، فإن اللاعنف يبقى مجرد قرار فكري – والقرارات في المجال النفسي غير مهمة، بل تنطوي على شيء من النفاق على صعيد الوعي: إذا لم أكن أحب جاري، هل لقراري بأن أحبه من معنى أصلاً؟ هل يعني بأنه حين يأتي إليَّ سأكون لطيفًا معه، سأبتسم له، وأعبِّر عن حبي له؟! أنا في الداخل لا أحبه – إلا إذا كان على هواي –، بل إن بي في واقع الأمر رغبةً خفيةً بأن يكون على شاكلتي؛ لكني مع ذلك أظهِر له الحب على مضض لأنني “قررت” أن أتغاضى عن أخطائه وأتغلب على مشاعري السلبية نحوه – وفي هذا نوع خفي من النفاق. فما هو جوهر النفاق؟ هو أن أسقِط خارجيًّا صورة هي غير ما أنا عليه داخليًّا – والنفاق قطعًا ليس “فضيلة”! بالمثل، بوسع المرء أن يقرر أن يصير نباتيًّا، ألا يؤذي أحدًا، أن يساعد كبار السن على عبور الشارع، أن يعتني بالمريض والجريح والمعوق والمعنَّف إلخ، لا لشيء إلا لأنه قرر أن يفعل هذه الأشياء؛ لكنه، داخليًّا، قد يكون شديد القسوة والعنف، وهذه القسوة وذاك العنف يظهران دومًا بطريقة أو بأخرى. من ذلك ما يسمى “التسامح”: هل أقبل الآخر على ما هو وكما هو على الرغم من اختلافه عني، أم ببساطة لأنه مختلف عني؟ وهل يجوز أن “نتسامح” مع العنف؟! (الفارق الدلالي شاسع بين التسامح tolerance وبين المسامحة forgiveness.) ما أكثر ألاعيب النفس البشرية!
حين تكون ممارسة الفضيلة بقرار ذهني بحت فهي ليست بفضيلة، وإن تستَّرتْ بلبوسها. ولعل هذا هو المغزى العميق من قول گاندهي ما مفاده إنه خير للإنسان أن يختار صراحة طريق العنف ذودًا عن نفسه وأهله أو طلبًا لحقِّه من أن يختار اللاعنف وهو عنيف. بعبارة أخرى، هل اللاعنف هو، فعلاً، “لا” ناهية للعنف، أي حاسمة للعنف النفسي بكل أشكاله، أم أنها مجرد خيار فكري في جملة خيارات أخرى متاحة؟ مَن يحب فعلاً، مَن يلتهب قلبه بالمحبة، غير مخيَّر أصلاً بين أمرين!
التدين، بالمثل، ليس قضية ذهاب إلى مسجد أو كنيسة أو معبد، ليس قضية أداء عبادات أو مناسك أو شعائر معينة. فما أسهل ذلك! بوسع أيٍّ كان أن يؤدي هذه كلها ويشعر، بعد أن يفعل، أنه “متدين”، لكنْ من غير أن يكون ديِّنًا حقًّا. لقد أشار كريشنامورتي إلى الخطر الماثل في الركون إلى الشعور المريح بأننا فاضلون من غير أن نكون كذلك فعليًّا. تحقيق الفضيلة عنده ثمرة طبيعية من ثمار معرفة النفس؛ ومعرفة النفس لا تكون إلا بإحاطة كلية بمحتوى الوعي وبفهم عميق لكيفية اشتغال الذهن – وهذا عينه طلب الحقيقة لذاتها. الدين الحق عنده لا يفترق عن طلب الحقيقة هذا. وقد كان كذلك على ما يبدو بنظر گاندهي أيضًا، إذ جعل حياته نفسها “قصة اختبارات مع الحقيقة”[5]. كلاهما إذن – گاندهيجي وكريشناجي – نظر إلى الدين بوصفه طلبًا للحقيقة لا يهادن. الذهن الديِّن بحق هو الذهن الذي يستغرق في قلب متعطش إلى الحق. الفارق الظاهر بين الرجلين يتمثل في الرسالة التي أخذها كلٌّ منهما على عاتقه كغاية لحياته وعمله؛ الفارق هو في المظهر الخارجي، لكننا، عند كليهما، نجد على مستويات أعمق تلك الحاجة عينها إلى التحول الداخلي، تلك الحاجة إلى ذهن ديِّن، لا الإصرار على التماهي الذهني الخارجي مع الملة أو الطائفة أو المذهب؛ تحقيق الفضيلة كثمرة لمعرفة النفس، لا كقرار خارجي بحت.
لا أظن أن حياة گاندهي العامة والإصلاحات التي ألهمها كان يمكن لها أن تكون ما كانت لولا حضور هذه القوة الداخلية في حياته. بقول أوضح، لولا محبة گاندهي للإنكليز فعلاً بوصفهم بشرًا، لولا “لاعنفه” الداخلي، لولا نطقه بـ”لا” الناهية للعنف، لما استطاع أن يحرر وعيه من كره أي إنسان، بصرف النظر عن صفاته وانتماءاته؛ ولو لم يتحرر من الخوف، لما أفلح في أيٍّ من مساعيه الخارجية. بعبارة أخرى، ليست القضية مجرد إصلاح اجتماعي يأخذ المرء إنجازه على عاتقه، بل قضية الدوافع، قضية النوايا العميقة التي تطلق عملية الإصلاح: إذا حصل كتجلٍّ طبيعي لحال داخلية، فهو غيره إذا كان مجرد إعمال لخطة محسوبة يتوفر على وضعها ذهن حاذق.
* * *
كثيرًا ما يطرح نقاد اللاعنف (حتى لا نقول “خصومه”) مسألة الإستراتيجية اللاعنفية الگاندهية كجزء من “تكتيك” لجأ گاندهي إليه لأن الإنكليز كانوا الأقوى ماديًّا ولأن حظوظ العنف من النجاح في الهند كانت واهية أمام خصم متعنت مثل “الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس”. فهل اختار گاندهي اللاعنف لهذا السبب؟ هل اتخذ اللاعنف طريقة بعد استقرائه الواقع وقراره بأن حظوظ اللاعنف من النجاح أكبر من حظوظ العنف؟ أم أن قراره كان قرارًا “دينيًّا” بالمعنى الذي ذكرنا، بصرف النظر عن النجاح أو الإخفاق؟ عند الذهن الديِّن، إذا كان هذا هو الأمر الصائب، فهو السلوك الأوحد لا محالة، وليس الأمر قضية قرار، بصرف النظر عن الإخفاق والنجاح. فالغاية، هاهنا بالذات، لا تبرر الوسيلة.
وإذن، فالسؤال الآن، بعبارة أخرى، هو: هل منهاج گاندهي ثمرة طبيعية للذهن والقلب الديِّنين لديه، أم أنه مجرد “إستراتيجية عمل لاعنفي” (جان-ماري مولِّر) يجب اتباعها؟ أغلب مَن يسمون أنفسهم “لاعنفيين” اليوم يعتمدون نهج اللاعنف تكتيكًا ولا يبتغون منه الغاية نفسها. لقد قال المعلم الناصري في الموعظة على الجبل: “مَن لطمك على خدك الأيمن فاعرضْ له الآخر” (إنجيل متى 5: 39). فهل العمل بحدِّ ذاته هو ما يهم؟ إذا اكتفيتُ بعرض الخد الآخر، لكني من الداخل لا أزال غاضبًا كارهًا، فعملي لن يكون له أي مفعول. ما يُحدِث التحول في الخصم ليس مجرد عرض الخد الآخر، بل المحبة والرحمة اللتان ينبع منهما هذا النوع من السلوك كفيض عفوي. إذ ذاك لا أردُّ، لا أواجه العنف بالعنف، ولا الكراهية بالكراهية، أنطق بـ”لا” الناهية للعنف من غير جهد. لدينا مثال آخر على ذلك عندما التقى البوذا المجرم أنگولمالا وهداه[6]. حال البوذا الباطنة هي ما يهم هنا: لسنا هنا أمام بوذا خائف، يستعمل اللاعنف تكتيكًا للتغلب على أنگولمالا؛ ليس التكتيك ما نفع هنا مع القاتل، بل مفعول صفة القلب الديِّن. بعبارة أخرى، هل كان اللاعنف الگاندهي نتيجة الإدراك الديني العميق أم كان مجرد مناورة سياسية؟ إذا قبلنا بمبدأ اللاعنف بوصفه تكتيكًا، لا يعدو الأمر الوعي السطحي وليس له، بالتالي، من قيمة تُذكَر؛ أما إذا وُلد الأمر من حال إدراك باطني آني، فنحن عندئذٍ نشارك في وعي گاندهي.
على النحو نفسه، بوسعنا أن نسأل: مَن هو المسيحي؟ ماذا يعني أن يكون المرء مسيحيًّا صادقًا؟ يبدو من الأناجيل أن المعلم الناصري عاش تلك المحبة والرحمة ونطق عن ينبوع تلك الحقيقة، عن تلك الحال الباطنة، وأراد أن يعبِّر عنها. لكن غالبية أتباعه لم يعرفوا محبته ورحمته، بل اكتفوا بمجرد التقاط التفاصيل الخارجية وحولوها إلى مناسك وشعائر، ثم ما لبثوا أن اختلفوا في الرأي على كيفية أداء هذه المناسك والشعائر، على أي الوصايا يجب التقيد بها أكثر من غيرها وإلى أي حد، بما فيها وصية “عدم مقاومة الشر بالشر”؛ لا بل انقسموا متخالفين حول “طبيعة” المسيح و”إرادته” إلى ملل وطوائف يصعب اليوم حصرها. يدَّعي الكاثوليك والپروتستانت جميعًا الانتماء إلى المسيح، لكنهم ظلوا طوال خمسين عامًا يقتتلون في أيرلندا! فهل يجوز لمن يقتل إنسانًا مثله باسم الدين أن يتسمَّى بالمسيح؟!
ومنه، ليس للتدين من صلة بتاتًا بالمظاهر الخارجية مادام المرء لم يحقق الذهن الديِّن. قوة گاندهي وكريشنامورتي ليست في مسلك كلٍّ منهما العملي، بل في الوعي الباطن الذي حرَّك العمل. لقد تعاون گاندهي مع أناس مختلفين جدًّا معه، إنْ من حيث الدين وإنْ من حيث الانتماء الفكري، مثل أندروز وكالنباخ ونهرو وپاتيل وعبد الغفار خان وأبي الكلام آزاد إلخ، وتآخى معهم في الإنسانية والغاية، فكانت بينهم مودة صادقة. بعبارة أخرى، ما نحن هو الأصل، وما نعمل هو الفرع.
مَن هو الگاندهيُّ؟ مَن هو اللاعنفي؟ إذا أعملنا ذهننا عميقًا في السؤال، لوجدنا أن الگاندهيَّ الصادق، هو عينه المسيحي الصادق، هو عينه المسلم الصادق، هو عينه البوذي الصادق، هو عينه صاحب الذهن الديِّن. لقد أوجد البشر، الذين خلقهم الله “كنفس واحدة” (القرآن الكريم، سورة لقمان 29)، هذه التقسيمات من جراء انقسامهم أصلاً في الداخل، من جراء فهمهم السطحي للدين، فسموا أنفسهم مسيحيين، هندوسًا، مسلمين، لا بل “گاندهيين” و”كريشنامورتيين”! المشكلة، إذن، ليس في كون المرء گاندهيًّا أو كريشنامورتيًّا، مسلمًا أو مسيحيًّا – المشكلة الحقيقية هي السطحية. لقد كان خصم گاندهي وكريشنامورتي كليهما هو السطحية، هو قبول التراث النقلي الديني قبولاً أعمى، قبول “النقل” من غير “عقل”.
يذكِّرنا هذا بأن گاندهي لم يقاوم سياسة الإنكليز فقط، بل قاوم سياسة “المؤتمر” أيضًا حين شعر بأن الحزب انحرف عن مساره وأساء التصرف أخلاقيًّا. حدث ذلك، مثلاً، عند تقسيم الهند، حيث كان يجب تسديد بعض المال إلى الپاكستان، لكن الحكومة الهندية وضعت شروطًا للتسديد، قائلة إنها لن تسدده ما لم يلتزم الپاكستانيون أولاً فعل كيت وكيت. شعر گاندهي آنذاك بأن حكومة الهند تمارس سياسة ليَّ الذراع، وكان هذا بنظره من قبيل “الكفر”، فعارضه معارضة شديدة. قال گاندهي بأن الحرية السياسية ليست غاية المؤتمر الأساسية، بل خطوة أولى في سبيل تحرير قرى الهند من الفقر والخرافة والجهل. كان يريد للهند أن تكون أول بلد في العالم من غير جيش؛ كان يريد من القوم في المؤتمر أن يذهبوا ويعملوا في القرى، تاركين أمور الحكم للإداريين، لكن قلة قليلة منهم كانت راغبة في ذلك أو مستعدة له. ماذا حدث لجميع الأتباع الذين كانوا رفاقه في المؤتمر؟ لم يحققوا الوعي الذي حققه گاندهي، مكتفين باتِّباع الأوامر والنصوص؛ واتِّباع الأوامر والنصوص شيء سطحي لا يجدي نفعًا، كما بينت تجربة گاندهي وغيره من اللاعنفيين الكبار. ومنه، فإن الروح في المؤتمر سرعان ما انحطت برحيل گاندهي. والواقع أن سيرورة الانحطاط هذه كانت قد بدأت وهو حي بعدُ، مع دنوِّ الهند من الاستقلال وظهور تناقضات المطامح والأطماع على السطح، فكان گاندهي حزينًا بائسًا إبان الستة أشهر التي سبقت وفاته؛ وقد نُقل عنه قولُه إن تلك الفترة من حياته كانت أسوأ فترة عاشها لأنه آماله العراض بهند حرة، واحدة، غنية بروحها، تبددت أمام ناظريه من غير أن يستطيع فعل شيء يُذكر.
* * *
سيرنا “على خطى” أحد، إذن، ليس مجرد العمل على غراره ظاهريًّا – لا لشيء إلا لأنه ليس لدينا وعيُه. وهذا ما أشار إليه كريشنامورتي قائلاً بما لا لبس فيه: لا تتبع أحدًا، كنْ نفسك، ارصد كيف يشتغل ذهنك، افهم نفسك فهمًا كليًّا؛ فبفهمك نفسك ودوافعك العميقة، يحصل التحول فيك، وذاك التحول تحوُّل طبيعي من شأنه أن يُترجَم من فوره إلى سلوك، إلى عمل صائب. أما إذا حاولت أن تعيش على غرار إنسان آخر، فأنت لا تطيق ذلك، لأنك لم تحقق ذاك الوعي. لا أستطيع أن أعيش مثل گاندهي لأنني لا أملك فهم گاندهي فيَّ، وإذا لم أكن نفسي، لا أكون نفسي حتى، بل أصير منافقًا – وهذا أسوأ من أن أكون نفسي، على علاتي الكثيرة! عندما أكون نفسي، فلا يزال متاحًا لي أن أرصد نفسي كما أنا فعليًّا، لا كما أتمنى أن أكون، فأفهم نفسي أكثر – وهذه هي “الفعلية” actuality بحسب كريشنامورتي – وتكون حظوظي في اختبار “الحقيقة” truth أوفر.
عندما يتحقق المرء من واقع ما هو عليه بنفسه، يحدث التحول الداخلي في أعماق السريرة، ويتجمل بالحكمة والفضيلة بطبيعة الحال، فلا يقلد سواه. محاكاة الآخر كذبة كبيرة. ومنه، كان أكبر خطر نبَّه إليه كريشنامورتي هو التبعية لأحد، مهمَن كان؛ لذا رفض رفضًا قاطعًا اتخاذ أحد تلميذًا. قال ما مُفاده: ليس بمقدوري، ولا بمقدور أحد، أن يمنحك الحقيقة؛ فما الجدوى من التتلمذ عليَّ أو على سواي؟ عليك أن تكتشف الأمر بنفسك كما اكتشفته بنفسي، وعلى كلٍّ أن يصير “نورًا لنفسه” – وهو ما شدَّد عليه البوذا أيضًا.
من قراءتي گاندهي – وهي محدودة بالطبع – أشعر بأنه فهم حقيقة ذلك. ونقع على الحقيقة نفسها في الـبهگڤدگيتا، كتابه الأثير، حيث جاء بأن سداد العمل أو ضلاله لا يتوقف على النتيجة، بل على الدوافع. والگيتا توصي أيضًا بالعمل على غرار الإنسان الطَّموح، لكنْ من غير طُموح؛ ففيها يشرح السيد كريشنا لأرجونا بأن الإنسان المستنير يبدو في الظاهر وكأنه يعيش ويعمل مثل الإنسان العادي تمامًا، لكن هذا ليس صحيحًا لأن دوافع كلٍّ منهما مختلفة، الحال الداخلية عند كلٍّ منهما مختلفة. ومنه، فإن التحول الحقيقي كامن في وعي الإنسان. وقد ذهب كريشنامورتي إلى أنه فقط عندما يحدث هذا التحول يمكن لإصلاح طبيعي أن يتم في المجتمع؛ أما عندما يولد التغيير اعتبارًا من المصلحة الضيقة، من الطموح الشخصي، من عمل محسوب النتائج، فلا يحدث تغيير حقيقي في المجتمع، ولا يلبث “الإصلاح” أن يحتاج إلى إصلاح، وهكذا إلى ما لا نهاية.
سأل أحدهم كريشنامورتي بعد واحد من أحاديثه: “أريد أن أقوم بعمل اجتماعي، لكني لا أعرف كيف أبدأ؟” فأجابه:
أعتقد أن من المهم للغاية أن تكتشف لا كيف تبدأ العمل الاجتماعي، بل لماذا تريد أن تقوم به أصلاً. فلماذا تريد أن تقوم بعمل اجتماعي؟ ألأنك ترى البؤس في العالم – المجاعة، المرض، الاستغلال، اللامبالاة الوحشية للثراء الفاحش جنبًا إلى جنب مع الفقر المدقع، العداوة بين إنسان وإنسان؟ هل ذاك هو السبب؟ أتراك تريد أن تقوم بعمل اجتماعي لأن في قلبك محبة، وبالتالي، لست مباليًا بإنجازك الشخصي؟ أم أن العمل الاجتماعي وسيلة للتهرب من نفسك؟ أتفهم؟ ترى، مثلاً، كل ما ينطوي عليه الزواج التقليدي من قبح، فتقول: “لن أتزوج أبدا”، فتنهمك بدلاً من ذلك في العمل الاجتماعي؛ أو لعل والديك دفعا بك إلى القيام به، أو ربما كان لديك مثال. إذا كان الأمر مخرجًا للهرب، أو إذا كنت تسعى وراء مجرد مثال من وضع المجتمع أو زعيم أو كاهن، أو حتى من وضعك أنت، فإن أي عمل اجتماعي قد تقوم به سيوجِد المزيد من البؤس. أما إذا كانت في قلبك محبة، إذا كنت تطلب الحقيقة وكنت، بالتالي، إنسانًا ديِّنًا حقًّا، إذا لم تعد طَموحًا، لم تعد تطلب النجاح وفضيلتك لا تقود إلى “المحترمية” – فحياتك ذاتها عند ذاك ستساعد على إحداث تحوُّل كلِّي في المجتمع.
أعتقد أن فهم هذا مهمٌّ للغاية. فحين نكون في ريعان الشباب، شأن أغلبكم، ترانا نريد القيام بشيء ما، والعمل الاجتماعي ذائع الصيت: الكتب تخبِّر عنه، الصحف تروِّج له، هناك مدارس للتدريب على العمل الاجتماعي، إلى آخر ما هنالك. ولكنْ، كما ترى، من دون معرفة النفس، من دون فهم نفسك وعلاقاتك، فإن أي عمل اجتماعي تقوم به ينقلب في فمك إلى رماد.
الإنسان السعيد، لا المثالي ولا المتهرب البائس، هو الثوري بحق؛ والإنسان السعيد ليس صاحب الأملاك الكثيرة. الإنسان السعيد هو الإنسان الديِّن بحق، وأسلوب حياته بالذات عمل اجتماعي. لكنك إذا صرت مجرد واحد من حشد العاملين الاجتماعيين، سيظل قلبك خاويًا. قد تتصدق بمالك، أو تقنع غيرك من الناس بالإسهام بمالهم، وقد تقوم بإصلاحات رائعة؛ ولكن مادام قلبك خاويًا وذهنك يغصُّ بالنظريات، ستكون حياتك بليدة، مرهقة، عديمة الفرح. فافهم نفسك أولاً، ومن معرفة الذات تلك ينبع عمل من النوع الصحيح.[7]
من الخَطَل، إذن، أن يُظن بأن كريشنامورتي عارض الإصلاح الاجتماعي. فما شدَّد عليه هو أن الإصلاح نفسه يجب أن يتم عن قلب مُحب. قد ينخرط أحدهم في الإصلاح الاجتماعي، في نشاطات المجتمع المدني، في إستراتيجيات عمل لاعنفية، إلخ؛ لكنه إذا فعل هذا عن طُموح، عن أنانية، إذا فعله لكي يشار إليه بالبنان، فإن ذاك “الإصلاح” ينطوي على بذور فساده، وسوف ينقلب لا محالة في فمه إلى رماد.
لقد تبين لنا مرارًا وتكرارًا – ليس مما قلت، بل من عِبَر التاريخ – أن الإصلاح الخارجي لا يجدي نفعًا على المدى البعيد. الإصلاح الحق يأتي من الداخل. حتى محاولة گاندهي تشكيل مجموعة سياسية قوبلت بإحباط شديد لأن أتباعه لم يغيروا ما بأنفسهم، بل اكتفوا بقبوله زعيمًا سياسيًّا. أما هو فكان، على ما يبدو، يشعر بهذه الأمور في سريرته: كان عديم الخوف وكان يستعمل فطنته؛ كان مستعدًّا لمواجهة غضب المجتمع الهندوسي المتدين عندما حقن عجلاً تيسيرًا لموته من غير ألم شديد. لكننا إذا قمنا بالعمل الاجتماعي طلبًا للنجاح، فلا فارق بيننا وبين رجل الأعمال: رجل الأعمال يتحرق إلى النجاح، وكذلك رجل الدين، وكذلك العامل الاجتماعي، لكنْ بوسائل مختلفة؛ رجل الأعمال واضح النوايا على الأقل! إذا كان الإصلاح مجرد وسيلة إلى هدف، فإن مغزاه ضئيل، لأن الطموح (= الطمع) ينطوي على بذور الشقاق والانقسام. ويعلِّمنا التاريخ أنه لا بدَّ للانقسام من أن يظهر ضمن حركة الإصلاح، ومعه العداء، فيبدأ القوم بالتنازع فيما بينهم! قد تكمن تلك الانقسامات في النفوس مؤقتًا، فلا تظهر بتأثير نسوة ورجال عظام مثل گاندهي، لكن الانقسام يظهر فيما بعد حتمًا ويهدر مكتسبات الإصلاح؛ وقد تتلاشى ثمار الإصلاح تمامًا لدى غياب تأثير الكاريزما القاهر. ومنه، نستنتج أن الفضيلة لا تُكتسَب عبر تأثير أيٍّ كان وأن على كلٍّ منا أن يحققها بنفسه. إذ ذاك، بحكم حال الفهم – فهمي لنفسي، فهمك لنفسك – ترانا ندرك فورًا مسار العمل الصحيح الذي يناسب كلاً منا.
مَن أرشد گاندهي، فعمل ما أراد أن يعمل؟ لم يرشده أحد بعينه. مَن أرشد البوذا؟ مَن أرشد سقراط؟ لكن في كلٍّ منا رغبة خفية في الانقياد، في أن يرشدنا أحدهم في حياتنا ويملي علينا وجهة العمل الصحيح. لذا من المهم أن ندرك أن اتِّباع أيٍّ كان يضعنا “تحت مظلته”، إذا جاز القول، يحدِّد لنا سقفًا لا نقدر أن نتخطاه، يجعل منا بشرًا “مستعمَلين” second-hand. أما إذا تحققنا بفهم أنفسنا بأنفسنا، فإن ذاك الفهم يتجلى آنيًّا عملاً فعالاً، لكنه في هذه الحال عمل أصيل، خلاق. إذا كان قلبي عامرًا بالمحبة، بالرحمة، وأمْلَتْ عليَّ محبتي أو رحمتي نذر نفسي للإصلاح، فدوافعي إذ ذاك سليمة، وعملي سليم بالضرورة.
* * *
خلاصة القول إنه لا يبدو لي أن هناك تناقضًا بين ما كان گاندهي يسعى فيه وبين تعليم كريشنامورتي. تعليم كريشنامورتي ينطوي على مفتاح التحول الداخلي الجذري المطلوب منا كبشر جديرين باسم إنسان، لكنه ليس البتة دعوة إلى القعود عن العمل. إنه يشدد فقط على أن العمل يجب أن ينبع من قلب سليم، مُحب، لا من ذهن طَموح، وضيع، متمركز على ذاته. ولا أحسب أن گاندهي كان ليختلف معه على ذلك، لأن قلبه كان عامرًا بالأخوة الإنسانية الشاملة. كان يشعر بمودة حقيقية حيال الإنكليز، يشعر بأن الإنكليز أصدقاء للهنود، بأنهم بشر كسواهم؛ لم “يشيطنهم” في أي لحظة من جهاده ضدهم، على الرغم من قناعته التامة بأن حكومتهم يجب أن تغادر الهند لأنها ظالمة، جائرة. لقد ثار گاندهي على الظلم، لا على الإنكليز الظالمين. ومن منظور تاريخي، نسبي بالضرورة، ظلت العلاقات بين الهند وبريطانيا ودية، وظلت الهند جزءًا من الكومنولث نتيجة لتلك السياسة الراقية؛ وتلك السياسة نبعت من فهم “ديني” عميق لطبيعة الإنسان، فيما يتعدى الزمان والمكان.
إن مثل هذا الفهم، مثمرًا عند إنسان واحد، أهم بما لا يقاس من ملايين الأتباع العميان. ومادمنا لم نحقق هذه الصفة الجوهرية التي حققها گاندهي، مكتفين بالأعمال الظاهرة التي أوصى بها، ترانا لن نفلح في شيء، وسيكون أي علاج أسوأ من الداء نفسه. تعود أسباب نجاح حركة اللاتعاون وحركة العصيان المدني والسياسات الاقتصادية التي ألهمها گاندهي نجاحًا نسبيًّا إلى فطنتها النابعة من ذهن وقلب ديِّنين – وذاك القلب الديِّن، ذاك الذهن الديِّن، هو عينه ما يدعونا كريشنامورتي إلى تحقيقه.
كلا الحكيمين قال “لا” ناهية للعنف بكل أشكاله…
مرمريتا، 3 تموز 2010
* حديث ألقيَ ضمن فعاليات ورشة مجلة معابر (www.maaber.org) اللاعنفية السنوية بعنوان “اللاعنف: بعض الجوانب الفلسفية”، مرمريتا (سورية)، 2-4 تموز 2010.
[1] للاطلاع على موجز عن حياة كريشنامورتي وفكره، راجع: پوپول جيكر، “ج. كريشنامورتي: الرائي السائر وحده”، سماوات جديدة: http://www.samawat-jadidah.org/j_krishnamurti/about_k/the_seer_who_walks_alone-pupulji.
[2] للاطلاع على موجز عن حياة گاندهي وجهاده، راجع: ديمتري أڤييرينوس، “م.ك. گاندهي بين القداسة والسياسة”، سماوات جديدة: http://www.samawat-jadidah.org/nonviolence/essays_and_papers/gandhi_between_sainthood_and_politics-dna.
[3] راجع مثلاً: ج. كريشنامورتي، “أنت العالم”، سماوات جديدة: http://www.samawat-jadidah.org/j_krishnamurti/by_k/thou_art_the_world.
[4] راجع: ج. كريشنامورتي، “الصورة”، سماوات جديدة: http://www.samawat-jadidah.org/j_krishnamurti/by_k/self-image.
[5] راجع: غاندي، م.ك.، قصة تجاربي مع الحقيقة (سيرة المهاتما غاندي بقلمه)، بترجمة منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، طب 7: 2007.
[6] See: Edward J. Thomas, The Life of the Buddha as Legend and History, Routledge & Kegan Paul, London, 1975, pp. 121-122.
[7] Krishnamurti, Think on These Things, Edited by D. Rajagopal, ch. 27, Harper Perennial, 1989, pp. 242-243.